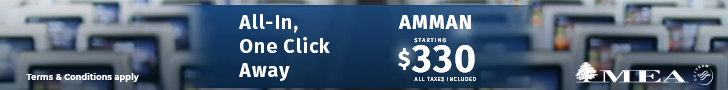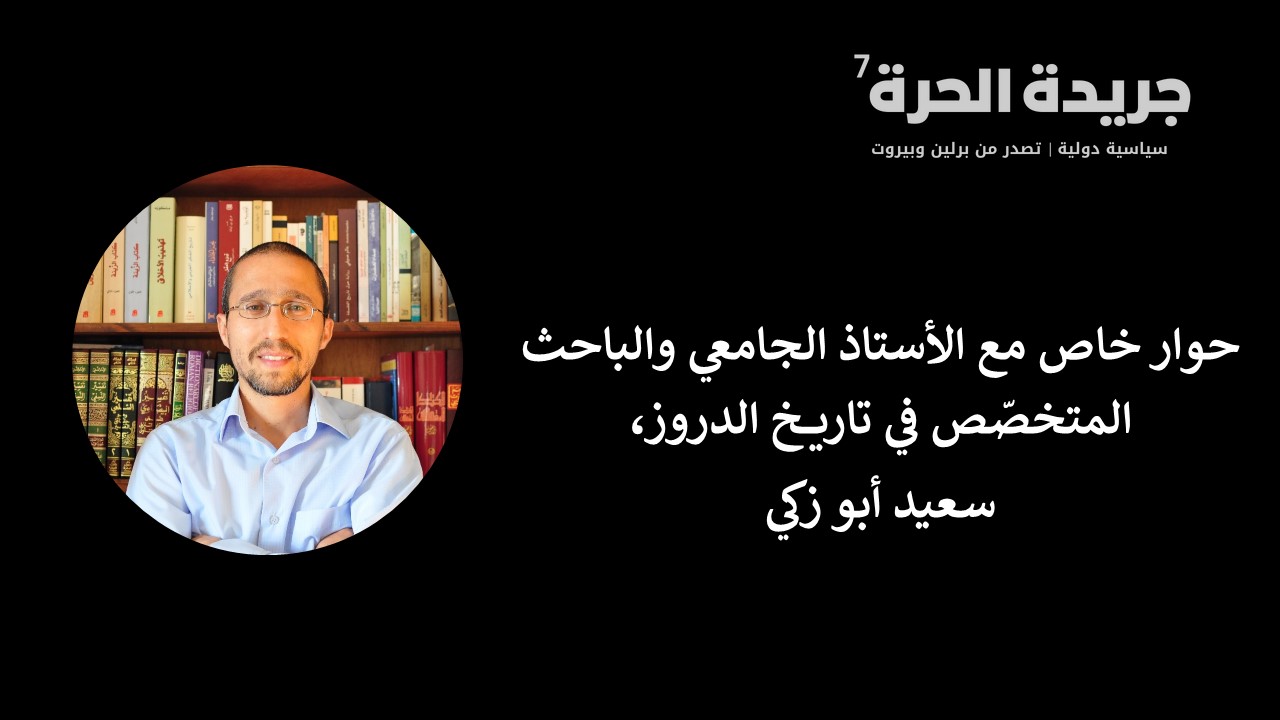
الحرة بيروت ـ حوار خاص مع الأستاذ الجامعي والباحث المتخصّص في تاريخ الدروز، سعيد أبو زكي،
تُشكّل المؤسسة الدينية الدرزية في جبل العرب ركيزة أساسية للحياة السياسية والاجتماعية، حيث يتداخل البعد الروحي بالواقع المعقّد الذي تعيشه المنطقة. في ظل التوترات الإقليمية والتغيرات السياسية المتسارعة، تبرز مكانة مشايخ العقل الثلاثة كقيادات دينية واجتماعية تحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن الطائفة وحقوقها الاجتماعية والسياسية في النظام السياسي الجديد في الجمهورية العربية السورية. لكن ما هو الدور الفعلي الذي يضطلعون به اليوم؟ وكيف تؤثّر مواقفهم في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه محافظة السويداء؟
في هذا الحوار الذي أجرته “جريدة الحرة“ مع الأستاذ الجامعي سعيد أبو زكي، وهو باحث متخصّص في تاريخ الدروز، ولا سيّما تنظيمهم الديني، نستكشف أبعاد هذه القضايا، بدءًا من موقف مشايخ العقل من تسليم السلاح، مرورًا بالتحفّظات على الدستور المؤقت، وصولًا إلى تأثير الاحتلال الإسرائيلي على مواقف الطائفة، والعلاقة بين دروز السويداء والقيادات الدرزية اللبنانية. ويستند أبو زكي في إجابته على هذه الأسئلة إلى وقائع كثيرًا ما تغيب عن التغطيات الصحفيّة لهذا الموضوع.
من هم مشايخ العقل الثلاثة وما الدور الذي يؤدونه في جبل العرب اليوم؟
حتى الآن، لا توجد دراسة علمية دقيقة توضح تاريخ مشيخة العقل في جبل حوران أو محافظة السويداء، لكن هناك معرفة أولية عن نشأتها ودورها في محطات تاريخية مهمة. كما أنه لا يوجد تعريف رسمي لوظيفتها في سوريا، إذ تبقى مؤسسة عرفيّة – بخلاف لبنان، حيث هناك قانون صدر حديثًا في العام 2006 ينظّم عمل شيخ العقل حاضرًا؛ وفلسطين المحتلة، حيث هناك قانون أيضًا، صدر في العام 1963، ينظّم عمل المؤسسات الدينية للدروز، ولاسيما منصب رئيس الطائفة الروحي.
يعود تاريخ ظهور مشايخ العقل في جبل حوران إلى القرن التاسع عشر، وتحديدًا بعد عام 1830، عندما برز الشيخ أبو حسين إبراهيم الهجري الذي لعب دورًا محوريًا، إلى جانب زعيم الدروز في تلك المنطقة، الشيخ يحيى حمدان، في قيادة الدفاع عن جبل حوران ضد حملة إبراهيم باشا، ابن والي مصر العثماني محمد علي باشا، والذي تمرّد على السلطان العثماني محمود الثاني واجتاح بلاد الشام أواخر عام 1831 بدعم فرنسي. اتّسم حكم محمد علي باشا في بلاد الشام بالظلم والاستغلال، إذ فرض ضرائب باهظة، وأجبر السكان على السخرة والتجنيد الإجباري، واحتكر القطاعات المنتجة في الاقتصاد المحلي.
في أواخر عام 1837، فرض إبراهيم باشا التجنيد الاجباري ونزع السلاح على حوران، فرفض الدروز الأمرَين لأنهما يعرّضان قراهم هناك للانكشاف أمنيًا أمام غزوات البدو. غير أن إبراهيم باشا أصرّ على قراره ما أدّى إلى اندلاع ثورة قادها دروز حوران، وساندتهم فيها قبائل بدو من سنّة حوران الذين كانوا يعانون من الظروف نفسها. استمرت الثورة تسعة شهور، وأسفرت عن خسائر فادحة في جيش إبراهيم باشا الذي فقد ما بين 15 إلى 20 ألف جندي، بينما لم يتجاوز عدد الثوار، دروزًا وبدوًا، الـ1600 مقاتل!
برز في هذه الفترة الشيخ أبو حسين إبراهيم الهجري قائدًا روحيًا، ما أدّى إلى تأسيس مشيخة عقل لعائلته في قنوات، وترسّخت مشيخة العقل كقيادة روحية مرتبطة بالإرشاد وصيانة مجتمع الدروز في الجبل والدفاع عن الأرض والعرض. وفي الوقت ذاته، برز الشيخ أبو علي قسّام الحناوي، مؤسّس مشيخة آل الحناوي، الذي شارك في الثورة ضد إبراهيم باشا، وكذلك في ثورة 1852 ضد العثمانيين بسبب فرض الضرائب المجحفة والتجنيد الإجباري. والراجح أن الشيخ أبو يوسف حسن جربوع، وهو معاصر للشيخين الهجري والحناوي ومؤسس مشيخة آل جربوع، قد شارك أيضًا في هذه الثورات.
استقرت مشيخة العقل في هذه العائلات الثلاث وراثيًا، وتمركزت مشيخة آل الهجري في قنوات والريف الشمالي والغربي والشرقي للسويداء، بينما استقرت مشيخة آل الحناوي في سهوة البلاط والريف الجنوبي، ومشيخة آل جربوع في مدينة السويداء والقرى المجاورة. وهناك تراتبية عرفية اصطلح عليها دروز حوران، تضع مشيخة آل الهجري في المقام الأول، يليها مشيخة آل جربوع في المقام الثاني وبعدها مشيخة آل الحناوي في المقام الثالث. وتحتوي المصادر التاريخية الأساسية والوثائقية التي تعود إلى القرن التاسع عشر أدلة عديدة على كون مشيخة آل الهجري لها المكانة الأولى بين الثلاثة، وهو ما يفسّر اللقب الرسمي للشيخ حكمت الهجري في وقتنا هذا، وهو الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، وهو لقب لا يطلق على شيخَي العقل الآخرَين.
ما هي أهمية المؤسسة الدينية الدرزية في صياغة القرارات السياسية والاجتماعية؟
في القرن التاسع عشر كان في بلاد حوران قيادة سياسية مستقلة عن مشايخ العقل. فسادَ المشايخ بيت حمدان في النصف الأول من القرن، ثمّ برز دور قيادة بيت الأطرش في نصفه الثاني بعد انقراض آل حمدان، وتعزز دورهم مع ثورة سلطان الأطرش في عام 1925. وبقيت القيادة الدينية المتمثلة بمشايخ العقل تمارس سلطة أبوية رعائية تُعنى بالمصالح الدينية وشؤون الطائفة العامة، دون المشاركة في أمور السياسة المباشرة. إذ كان دورهم الأساسي التوجيه والإرشاد، خاصة في الأزمات الكبرى.
وقد أضاء المستشرق البريطاني كولونيل تشارلز تشرشل على أهمية دور رجال الدين السياسي الجامع في مجتمع الدروز بما لديهم من حكمة في تدبّر شؤون طائفتهم وحرصهم على رعاية مصالحها وحفظ وجودها بعيدًا عن الانقسامات الفئوية، حيث قال أن “العقّال (أي رجال الدين) يؤلّفون نوعًا من مجلس شيوخ في جسم الدروز السياسي؛ فهم بيقظتهم المتنبّهة وبصيرتهم المميّزة يبسطون درعًا حاميًا على الطائفة بكمالها”.
ومع انطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد في العام 2011، تبنّت مشيخة العقل موقف الحياد، فرفضت الزج بأبناء السويداء في الحرب الأهلية، وساندت خيار شبان المحافظة الدروز بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية خارج حوران تجنّبًا للانخراط في الاقتتال الداخلي، ما أدّى إلى تخلف نحو 12 ألف عنصر عن الخدمة الإلزامية. وبالرغم من الضغوط، بقيت مشيخة العقل حريصة على عدم استثارة النظام السوري، حرصًا على سلامة الجبل، لكنها في الوقت ذاته، تبنّت سياسة وطنية – كان دعم رفض التجنيد أحد أعمدتها – تحفظ العيش المشترك، من جهة، وتصون وحدة سوريا، من جهة أخرى.
كيف يؤثر موقف مشايخ العقل على المجتمع الدرزي في ظل التوترات الإقليمية؟
يحظى مشايخ العقل في جبل حوران باحترام شديد نظرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره وتجنب الانزلاق إلى الصراعات المدمّرة، لا سيما في ظل التجارب السابقة التي كشفت عن أساليب تعامل النظام السوري مع المناطق التي خرجت عن سيطرته، من تفجيرات وقتل ودمار. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد عام 2020، برز الشيخ حكمت الهجري كأحد أبرز الشخصيات الدينية التي تبنّت خطابًا أكثر انفتاحًا على مطالب الحراك الشعبي الذي ثار سلميًا ضدّ النظام العاجز عن إيجاد حلول فعّالة لمشاكلهم الاقتصاديّة المرهقة، مؤكّدًا ضرورة السير في مسار سياسي يتماشى مع القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السوريّة، وعلى رأسها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
وفي حين اتسم موقف الشيخ يوسف جربوع بمهادنة النظام، واستمرّ الشيخ حمود الحناوي بنهجه الداعم للحراك الشعبي ضدّ النظام، تصدّر الشيخ الهجري المشهد كقائد روحي للحراك، حيث لعب دورًا محوريًا في ضبط سلميته وإضفاء بُعد اجتماعي وأخلاقي عليه. أما بالنسبة للشباب الدروز، فلم يكن الوضع سهلًا عليهم بعد أن رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذ اضطر البعض إلى مغادرة الجبل، بينما لجأ آخرون إلى العمل في مجالات لا تتناسب مع اختصاصاتهم لدفع الفدية المالية للامتناع عن الخدمة العسكرية وتجنّب الانخراط في الحرب الأهليّة. وكان رفض هؤلاء الشباب المشاركة في النزاع الداخلي موقفًا مبدئيًا، وللّذين يشكّكون اليوم في وطنيتهم، فهم يتجاهلون حقيقة أن رفضهم جاء رفضًا للقتال بين أبناء الوطن الواحد، وليس تنكرًا لوطنيتهم.
وهنا لا بدّ من التذكير بأنّه، وفي ذروة الحرب الأهلية بين عامي 2014 و2016، شكّلت محافظة السويداء ملاذًا آمنًا للكثير من السوريين الفارّين من درعا وغيرها من المناطق السوريّة، حيث استقبلهم أهالي المدينة في تأكيد على حرص أبناء المحافظة على التعايش الوطني. لذلك، هم اليوم يرفضون التشكيك بوطنيتم.
كيف تطوّرت مواقف مشايخ العقل؟
حافظ مشايخ العقل على سياسة التوازن بين ضرورة حماية محافظة السويداء ومنع الاقتتال الداخلي، غير أن المعادلة بدأت تتغيّر، كما ذكرت، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام السوري عن تأمين مقوّمات العيش الكريم. ففي عام 2020، بلغ الفقر مستويات غير مسبوقة، ما دفع الشيخ الهجري إلى اتخاذ خطوات متدرجة باتجاه الحراك الشعبي، بعدما أدرك أن المسألة لم تعد محصورة بالسياسة، بل باتت تمسّ القدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
في هذا السياق، تبنّى الشيخ الهجري رؤية تستند إلى القرار الدولي 2254، الصادر في 18 كانون الأول 2015، والذي نصّ على “وقف الهجمات ضد المدنيّين، وإطلاق مسار تفاوضي بين النظام والمعارضة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي، تُفضي إلى حكم غير طائفي وشامل يتمتع بالمصداقية”.
رأى الشيخ الهجري في هذا القرار المسار الأنسب لإنهاء الحرب الأهليّة المدمّرة وضمان استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، رافضًا الاتهامات التي تربط بين تبنّيه هذا القرار وبين مشاريع التقسيم. وبدعمه للحراك الشعبي، أعاد الهجري الزخم إلى دوره القيادي، كما عزّز الطابع السلمي والمنضبط للحراك، مع التأكيد على الالتزام بالمسار السلمي لحل الأزمة السوريّة، وفق القرارات الدولية.
ما هي مخاوف القيادات الدينية الدرزية في السويداء وأسباب رفضها تسليم السلاح؟ وما هي تحفّظات مشايخ العقل على الدستور المؤقت في سوريا والبدائل المطروحة؟ أسئلة نعالجها مع الباحث سعيد أبو زكي في الجزء الثاني ما قبل الأخير.