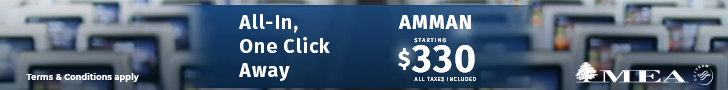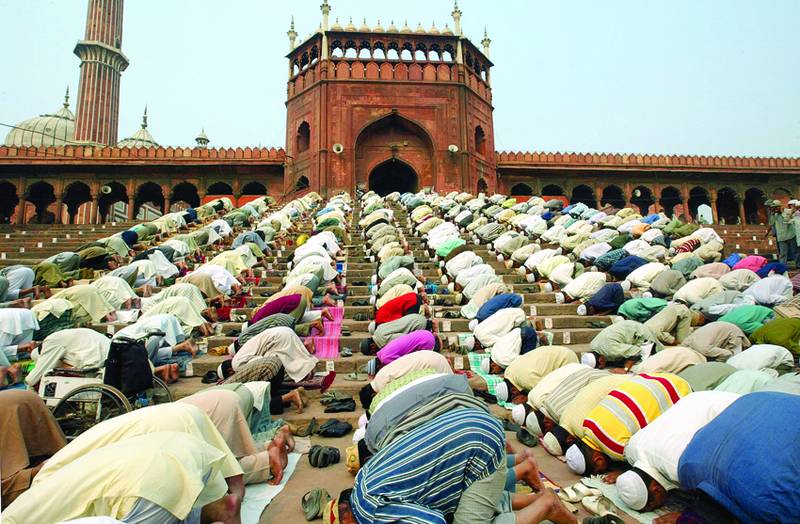
لقد كان الحكم في الإسلام على توالي العصور يقوم على الحكم الفردي الاستبدادي المطلق القائم على إرادة فرد واحد هو الخليفة أو الإمام أو السلطان ، والذي لا يعلو عليه أحد ولا تقوم الى جانبه هيئة اجتماعية لها صفة شرعية تقاسمه الحكم أو تسدي إليه المشورة والنصح في إدارة شؤون الدولة ، ولم يعرف المسلمون الحكم الشعبي وقد خلت الشريعة الإسلامية من أي تشريع يتعلق بنظام الحكم في الإسلام سوى آية وردت في القرآن وهي : ” والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ” .
وقد تجنب رجال الفقه الإسلامي البحث في هذه الشورى وفي أي بحث آخر يتعلق بنظام الحكم في الإسلام ، لما له من مساس بسلطة الخليفة المطلقة ، وكان الحكم في الإسلام ينتقل من خليفة الى آخر ومن سلطان الى سلطان بطريقة الاستخلاف ، أي بعهد من الخليفة السابق الى الخليفة اللاحق والذي يكون عادة من أسرة واحدة ، وقد استمد المسلمون هذا النظام وقواعده من النظام القبلي الذي كان سائداً في الجزيرة العربية عن ظهور الإسلام واستمر قائماً على توالي العصور .
وقد كان الناس في المجتمع الإسلامي منقسمين الى طبقة أحرار وطبقة أرقاء والى طبقة رجال وطبقة نساء ، ولم يكن الناس متساوين في الحقوق بين طبقة وأخرى ، وكان الأرقاء يعتبرون في عداد الأموال والحيوانات التي تباع وتشترى وتورث دون أن يكون لها حقوق البشر ، وكانت المرأة الرقيق تستعمل للمتعة الجنسية دون أن يكون لها حقوق الزوجة ، وقد بقي هذا النظام قائماً على توالي العصور الى أن زال في عصرنا بفضل الحضارة الحديثة التي ألغت الرق في العالم واعتبرته جريمة إنسانية وأعلنت المساواة في الحقوق بين الناس ، وتتمثل هذه المساواة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ألغى التمييز بين البشر وساوى في الحقوق بين المرأة والرجل .
وكان العالم الإسلامي على توالي العصور خالياً من السلطة التشريعية اللازمة التي تشرع للناس على الدوام حاجاتهم الزمنية المستجدة وقد حصر رجال الفقه الإسلامي أحكام الشريعة بما جاء في الكتاب والسنة ، ولم يعطوا حق التشريع لأي إنسان أو جماعة بعد وفاة النبي – ص ، لا بتغيير وتبديل ما شرعه الله ورسوله ولا بتشريع ما لم يشرعاه ، وبقي نظام الحكم في الإسلام على توالي العصور خالياً من السلطة التشريعية التي هي أساسية وضرورية في تقدم المجتمع وازدهاره .
وقد نشأ في غياب السلطة التشريعية في المجتمع الإسلامي أن حل الاجتهاد محل هذه السلطة ، لاستنباط أحكام للمسائل التي لم تنص عليها الشريعة الإسلامية ولم يحصر رجال الفقه الإسلامي حق الاجتهاد بفرد أو جماعة ، وإنما أعطوا لكل مسلم حق الاجتهاد دون أن يكون لاجتهاد أحد صفة الإلزام لأحد آخر ، وقد اختلفت الاجتهادات وتشرذم الناس حولها بسبب الصفة الدينية التي أعطيت لها ، ونشأ عن اختلافها قيام المذاهب الفقهية التي تحولت الى مذاهب دينية طائفية ، وصار القضاة في كل مذهب يستمدون أحكامهم من اجتهاد أئمتهم وكأنها هي الشريعة الإسلامية واختلفت التشريعات بين المذاهب وتباينت الحقوق بين المسلمين وباعدت بينهم .
وجمع رجال الفقه الإسلامي بين العبادات والمعاملات وكونوا منها شريعة واحدة هي الشريعة الإسلامية وصبغوها بصبغة دينية ضيقة ذات أبعاد محدودة غير قابلة للتغيير والتعديل والتوسع حسب مقتضيات توسع المجتمع ونموه ، وتنحصر أحكام الشريعة بالنسبة للمعاملات في ثلاث مسائل فقط هي : المعاملات المدنية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الناس من بيع وإيجار ورهن وهبة .. الخ ، واحكام الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وإرث ، والعقوبات التي تفرض على مرتكبي الجرائم ، وإن كل ما جاءت به الشريعة في غير ذلك لا يدخل في نطاق التشريع ولا يشكل تشريعاً عاماً يصلح للتطبيق في المجتمع .
إن الأبحاث الطويلة التي طرحها رجال الفقه الإسلامي حول هذه المعاملات واختلفوا فيها ليست هي الشريعة الإسلامية وهي غير ملزمة للأخذ بها ، فمعظم أحكام الأسرة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية كانت أيضاً استمرار للعادات والأعراف التي كانت سائدة في الجاهلية عند ظهور الإسلام ما عدا القليل منها الذي ألغته أو عدلته ، فقد كان تعدد الزوجات شائعاً في الجاهلية دون أن تكون له حدود معينة وقد أقرته الشريعة الإسلامية بعد أن قيدته بأربع زوجات .
وكان الطلاق في الجاهلية بيد الرجل وكانت المرأة محرومة من حق الطلاق لأنها كانت بعرف الناس ملكاً للرجل الذي اشتراها من أهلها بماله ودفع لهم ثمنها وهو المهر ، وهي لا تستطيع الانعتاق من ملكيته ما لم يسترد من أهلها المال الذي دفعه ثمناً لها وكانوا يسمونه الخلع ، وكان الطلاق في الجاهلية يقع باللفظ وكان اللفظ هو الأسلوب الوحيد للتعبير عن الإرادة في إبرام سائر العقود والتصرفات بسبب انتشار الأمية ، فقد كان غالبية الصحابة أميين وكان النبي أمياً كما نصت الآية : ” هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ” ، والآية : ” فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ” .