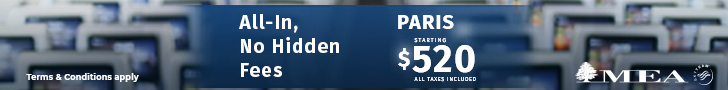في زمن الحروب الأهليَّة التي عصفت بلبنان لمَع شيخٌ تظهر على محيَّاه علامات الوقار والجلال، يحمل بيده قلمًا سيَّالًا معطاء، ويَرشح من فكره عِلم ثاقب منفتح على ثقافات العالم. يتحدَّث في محاضراته الجامعيَّة بِهمَّة وعزيمة ليبني جيلًا مثقَّفًا واعيًا من الشباب، فيحبُّه كلُّ مَن تابع دروسه، ويُعجب به كلُّ مَن قرأ لبِنات أفكاره ممَّا خطَّته كتبه ومؤلَّفاته. يخطُب على منابر المساجد فيُلهب الوجدان والمشاعر، ويقف متحدِّثًا في الندوات والمؤتمرات فيلفت الأنظار إلى ثقافته وسِعة علمه. ينبض في قلبه حبُّ لبنان، ويحمل في ضميره خَشيةَ ما يُحضَّر له من تمديد للحروب والمؤامرات والفتن على أرضه. في جعبته قناعة لا تُقهر بأنَّ لبنان لا يُبنى إلَّا بسواعد جيشه المؤتمَن الوحيد على الأمن والاستقرار، وليس بتفلُّت الميليشيات المسلَّحة. ذلك الشيخ – الذي أسكتته رصاصاتُ الغدر، وافتُتحت به قافلة المظلومين من أصحاب الرأي السديد الحرّ، ممَّن يُخشى من صولاتهم وجولاتهم وكلماتهم في نهضة لبنان واستقلاله عن التدخُّلات الخارجيَّة والإقليميَّة – هو الشيخ الدكتور صبحي الصالح (1926-1986).
في سيرة حياته بصمات تَشهد على مكانته الكبيرة وآثاره العلميَّة والدينيَّة في تاريخ لبنان الحديث، ولا سيَّما في دعوته الدؤوبة إلى الحوار الإسلاميّ – المسيحيّ، وإقصائه الأفكار والأوهام المتعلِّقة بإقفال باب الاجتهاد، وتشجيعه المرأة للنهوض جنبًا إلى جنب مع الرجل ومشاركته الحقوق والواجبات والأعباء ومسؤوليَّات الحياة.
تميَّز بأخلاقه الجمَّة الفاضلة ومساعدته الفقراء والأيتام والمحتاجين. وكان رفيقَ درب سماحة مفتي الجمهوريَّة الأسبق المظلوم الشيخ حسن خالد في مسيرته الإصلاحيَّة والتنظيميَّة للمؤسَّسات الدينيَّة والاجتماعيَّة للمسلمين في لبنان، الأمر الذي مهَّد لمأسسة دار الفتوى وإعادة تنظيم هيكليَّتها الإداريَّة وتطوير أنظمتها التشريعيَّة. بفضل هاتين الشخصيَّتين ارتقت دار الفتوى – وهي المرجعيَّة العليا التي تُمثِّل المسلمين اللُّبنانيِّين – إلى جانب البطريركيَّة المارونيَّة، إلى مرتبة المؤسَّستَين الدينيَّتين الأكثر نشاطًا وتأثيرًا وتداولًا في النشرات الإعلاميَّة في تاريخ لبنان.
أتمَّ الشيخ الصالح دراسته قبل الجامعيَّة في مسقط رأسه مدينة طرابلس. تلك المدينة التي تميَّزت تاريخيًّا بعناية المماليك بها، وحيث أنشأوا المدارس الدينيَّة التي خرَّجت ثُلَّةً من العلماء المشهورين فأثْرَوا تاريخ لبنان السياسيّ والدينيّ، وقد سُمِّيت في إثر ذلك بـ “مدينة العلماء”. احتضنت طرابلس حينها ثلاثمائة وستِّين مدرسة يرتادها الطامحون إلى التعليم العامّ كما إلى المناصب القضائيَّة والدينيَّة. وفي بداية القرن العشرين، استمرَّت بعض المدارس في توفير التعليم الدينيّ التخصُّصيّ، ومن بينها المدرسة المعروفة باسم “دار التربية الإسلاميّة” التي تأسَّست في العام 1924. في هذه المدرسة تلقَّى الشيخ صبحي الصالح تعليمه الدينيّ الابتدائيّ والثانويّ.
حرص الشيخ الصالح في دراسته الإعداديَّة والثانويَّة منذ سنِّ الثانية عشرة، على ارتداء زِيِّه الدينيّ. وقد مكَّنه ذكاؤه المتوقِّد في أثناء دراسته من أن يُستدعى للخطابة في صلاة الجمعة في مساجد طرابلس. وكان المصلُّون يأتون من جميع أنحاء المدينة للاستماع إلى خُطبه التي تميَّزت بسِعة أفقٍ وفصاحة، وقدرةٍ على إعطاء الحجج والإقناع.
بعد تخرُّجه وحصوله على الثانويَّة العامَّة الشرعيَّة واصل الشيخ تعليمه الدينيّ في جامعة الأزهر بالقاهرة. ومن بين الكلِّيَّات الثلاث المتاحة لحامِلي شهادة الثانويَّة الشرعيَّة لدار التربية والأزهر في لبنان وهي: كلِّيَّة الشريعة والقانون، وكلِّيَّة أصول الدين، وكلِّيَّة اللغة العربيَّة، اختار صبحي الصالح كلِّيَّة أصول الدين. في العام 1947 حصل على درجة اللِّيسانس في أصول الدين، ثمَّ في العام 1949 حاز درجة العالميَّة (الدكتوراة)، وما لبث في العام 1950 أن أضاف إلى شهاداته الدينيَّة المرموقة شهادةَ الليسانس في الآداب من جامعة القاهرة.
بعد تخرُّجه سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته العليا في جامعة السوربون. وفي العام 1954 حاز شهادة الدكتوراه في الأدب عن أطروحة بعنوان الدار الآخرة في القرآن الكريم[2].
وفي باريس، ساهم الشيخ صبحي الصالح، مع صديقه الحيدر أبادي محمَّد حميد الله، في تأسيس أوَّل مركز ثقافيٍّ إسلاميّ في العام 1952. وهناك واصل الوعظَ والإرشاد في أثناء صلاة الجمعة في مسجد باريس الكبير في منطقة Censier (بُني في العام 1922 على أنقاض المسجد الخشبيّ الذي أنشأ في العام 1916) . كما شارك في العديد من المناسبات العلميَّة في العاصمة الفرنسيَّة، حيث قدَّم الإسلام على أنَّه دينُ العدل والمساواة والإخاء. وكثيرًا ما أعرب عن رأيه بأنَّ الإسلام يُقدِّم استجابةً مناسِبة لتحدِّيات عصرنا.
وفي باريس تعرَّف على طالبة الدكتوراه عفَّت عكَّاري التي أصبحت فيما بعد زوجته، وعادا معًا إلى لبنان ليتفرَّغا للتدريس الجامعيّ، هو في مجال الشريعة واللُّغات والآداب، وهي في تدريس اللغة الفرنسيَّة.
ما إنْ عاد الشيخ الصالح إلى لبنان في العام 1955 حتَّى استُدعي إلى الخارج للتدريس في عدَّة جامعات. فعمِل في هذا الحقل لمدَّة اثنين وثلاثين عامًا؛ أوَّلًا في كلِّيَّة الشريعة في بغداد (1954-1956)، ثمَّ في كلِّيَّة الآداب في دمشق (1956-1963)، وفي الجامعة اللُّبنانيَّة حيث كان رئيسًا لقسم اللغة العربيَّة وآدابها ومديرًا لكلِّيَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة. وكان أستاذًا زائرًا ورئيسًا لقسم الشريعة الإسلاميّة في الجامعة الأردنيَّة، حيث شارك في وضع مناهجها الدراسيَّة (1971-1973). وفي سجلِّ الشيخ الصالح التعليميّ أيضًا أنَّه كان أستاذًا زائرًا في جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميّة في الرياض في العام 1980، وفي جامعة الزيتونة في تونس، من دون إغفال أنَّه كان أيضًا مديرًا لأبحاث طلبَة الدكتوراه في جامعتَي ليون الثالثة وباريس الثانية، وعضوًا في مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، ومجمع المملكة المغربيَّة، والمجمع العلميّ في العراق. كما كان عضوًا في الموسوعة العربيَّة الكبرى، وعُيِّن خبيرًا في الدراسات العربيَّة الإسلاميّة في اليونسكو.
وفي بيروت، كان بانتظاره سماحةُ المفتي الشيخ حسن خالد الذي وجد فيه نِعم الصديق الوفيّ، والذي كان من مميِّزاته تقريب العلماء الصادقين وإبعاد المتزلِّفين المتملِّقين، فعيَّنه نائبًا لرئيس المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى – الذي هو بمثابة برلمان مصغَّر عن الطائفة الإسلاميّة السنيَّة، ومهمَّتُه التشريع في الشؤون الدينيَّة والأوقاف للمسلمين. منذ هذا التعيين أصبحت نيابة رئيس المجلس مخصَّصةً لأحد العلماء من طرابلس.
أوَّلًا – مؤلَّفاتُه
ثمَّة سبعة عشر مؤلَّفًا لصبحي الصالح، بعضُها يركِّز على العلوم القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة، وبعضُها على الدراسات الفقهيَّة مثل: المباحث في علوم القرآن، وأثرُ الدراسات التاريخيَّة في علوم القرآن، وعلومُ الحديث ومصطلحه: عرضٌ ودراسة، ومقاييسُ النقد عند المُحدِثين، ومنهلُ الواردين: شرح رياض الصالحين للنوويّ، وأصولُ الفقه وتاريخه والاجتهاد وبعض النوازل الفقهيَّة المعاصِرة، ومعالمُ الشريعة الإسلاميّة، والنُظمُ الإسلاميّة: نشأتُها وتطوُّرها، والأمَّةُ ثمَّ الدولة، وأحكامُ أهل الذِمَّة لابن قيِّم الجوزيَّة (تحقيق وتعليق)، وشرحُ الشروط العُمَريَّة (مجرَّدًا من أحكام أهل الذمَّة لابن القيِّم)، وضبط وتحقيق وفهرسة نهجُ البلاغة، والمؤسَّساتُ الإسلاميّة تكوُّنها وتطوُّرها. وتناولت مؤلَّفاتٌ أخرى الدراسات الفلسفيَّة: فلسفةُ الفكر الدينيّ بين الإسلام والمسيحيَّة بالاشتراك مع لويس غرديه، جورج قنواتي. وفي مجال الفكر الإسلاميّ العامّ: ردُّ الإسلام على التحدِّيات المعاصرة (بالفرنسيَّة)، والإسلامُ والمجتمع العصريّ، والإسلامُ ومستقبل الحضارة، وتجربةُ التقريب في المشرق العربيّ، والمرأةُ في الإسلام. كما شارك مع دنيس ماسون في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيَّة، ومع سهيل إدريس في نشر القاموس العربيّ والقاموس الفرنسيّ. ونشر العديد من المؤلَّفات العلميَّة والأكاديميَّة باللغتين العربيَّة والفرنسيَّة في العديد من المجلَّات والموسوعات.
ثانيًا – أفكاره
كان الشيخ صبحي الصالح خطيبًا مفوَّهًا. وقد اشتُهر بقدرته على الإقناع والبرهنة من خلال بناء أفكاره بطريقة جدليَّة وجريئة. وكثيرًا ما كان يشارك في المناظرات العامَّة في لبنان وخارجه، مهتمًّا بالحوار والحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيِّين. من هنا برز تقاربُ أفكاره مع أفكار الأب يواكيم مبارك[3]. في هذا التقارب الفكريّ، أكَّد الشيخ الصالح اتِّفاقَه مع الأب مبارك على لقاء إنسانيٍّ مبنيٍّ على التراث الإبراهيميّ المشترك. يقول في إحدى لقاءاته: “نحن لا نطمح – في الشرق العربيّ – إلى طفرة ديموغرافيَّة تتحقَّق من خلال اعتناق الإسلام، بل نعمل على أن يحترم بعضُنا بعضًا، وأن يفهم بعضُنا بعضًا، وأن يتعلَّم بعضنا من تعاليم بعض، كما يجب علينا أن ننسى مآسي الماضي والظروف المؤسفة التي أضعفت روابطنا. ويجب أن نعمل على أن نبني تعاوننا على أساس الكرامة الإنسانيَّة كبشرٍ يحميهم إلهُ التوحيد… “.
ومن أوجُه التشابه الأخرى في تفكير الأب يواكيم مبارك والشيخ صبحي الصالح سعيُهما إلى إنشاء “مجلس إسلاميٍّ – مسيحيّ” يتمتَّع بسلطة معنويَّةٍ عالية. من أهداف هذا المجلس، كما يؤكِّد الشيخ الصالح، الحدُّ من نفوذ الزعامة الطائفيَّة أو المذهبيَّة التي يتقاسمها بعضُ رجال الدين، بمن فيهم المشايخ والقساوسة، مع الزعماء السياسيِّين. ومع ذلك، فهو يبتعد عن رأي الأب مبارك الذي كان يؤيِّد هدفًا ثانيًا يضمن الفصل بين الروحيّ والزمنيّ. بالنسبة إلى الصالح لا يجب أن يعني إنشاءُ هذا المجلس أن نتبنَّى الفصل بين الزمنيّ والروحيّ، باعتبار أنَّ الإسلام يتجاهل هذا التمييز بشكل عميق. وإذا ما تتبَّعنا فكر صبحي الصالح، يبدو لنا أنَّه يرفض اقتراح “الفصل” التامِّ والجامد لمصلحة “تنسيق” بين “شؤونِ ما هو زمنيّ” وشؤونِ ما هو “روحيّ”.
هناك مواقف أخرى في كتاباته وخطاباته تُميِّز فكره، وأهمُّها:
– الأصالة والحداثة: على الرغم من ثقافته المزدوِجة، فإنَّه حتَّى مع تمسُّكه بالإسلام التقليديّ، كان يوفِّق بين الأصالة والحداثة من خلال تأكيد نقاء الإسلام وحيويَّته، وقدرته على مواكبة العصر ودعوته إلى اللحاق بعلوم المستقبل.
– في الفلسفة، يشير إلى اختلافه مع كتابات ابنِ سينا وابنِ رشد وغيرهما من فلاسفة الإسلام، من دون أن يرغب في التقليل من مزاياهم كمفكِّرين عظام. ولكنَّه يظلُّ على حذره منهم كونهم انعكاسًا للفلسفة الهيلينيَّة. أمَّا الفلسفة الإسلاميَّة الأصيلة فهي ليست تقليدًا ولا تلفيقًا للفلسفة اليونانيَّة، وهي بعيدة عن هذا التصوُّر الفلسفيّ، بخاصَّةٍ وأنَّه من خلال القرآن الكريم والسُنَّة النبويَّة وكتابات المصلحين الإسلاميِّين الكبار تتجلَّى الملامح الأساسيَّة للفكر الفلسفيّ الإسلاميّ.
– في رفضه نزعة الانتقام : يدعو الشيخ الصالح إلى الحدِّ من اللجوء إلى الانتقام. ويقول في هذا الموضوع: “إنَّ تحريم الانتقام ليس بما يسبِّبه من اضطرابات اجتماعيَّة وحسب، بل لأنَّه يؤدِّي أيضًا إلى تعقيدات نفسيَّة لدى الطرف المعتدَى عليه. ويعترف القرآن الكريم بحقِّ الطرف المعتدَى عليه في طلب القصاص من المعتدي، ولكنَّه يوصي بالعفو والتسامح. ويترك تنفيذ العقوبة للحاكم أو من ينوب عنه. والغرض الوحيد من الاقتصاص هو أن يكون عِبرة للمجتمع”.
– في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: يؤكِّد أنَّ قيمته الأدبيَّة “كانت ولا تزال أكبر من قيمته القانونيَّة الفعليَّة”. ومع ذلك، فهو لا يزال يتحفَّظ على الكثير من بنوده خَشية أن تُستخدم كأساس للتهجُّم على خصوصيَّات الشريعة الإسلاميَّة السمحاء.
– المجتمع المثاليّ الإسلاميّ اليوم لا يزال مجرَّد مشروع لم يصل بعد إلى نموذج المجتمع الإسلاميّ الذي رُسمت خطوطُه الأولى في عهد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
– نظام الخلافة: ليس الشكلَ الوحيد للحُكم في الإسلام: “يجب أن نتوقَّف عن الاعتقاد بأنَّ هذا النظام التاريخيّ الذي قام على مبدأ الإجماع فقط هو الشكل الوحيد للحُكم في الإسلام”.
– الوحدة: في مقدِّمة كتاب نهج البلاغة للإمام عليّ يدعو صبحي الصالح المسلمين جميعًا إلى التوحُّد تحت راية التوحيد. ويدعو المؤرِّخين إلى تسليط الضوء على الحقائق، ليس انتصارًا لطرفٍ على طرف، بل دعوة خيِّرة لنسيان المآسي الدامية.
– اللجوء إلى الاجتهاد، بالنسبة إليه، لم ينقطع. فالقول بأنَّ الاجتهاد قد أُغلق في نهاية القرن الهجريّ الثالث وهمٌ بقي في أذهان الناس، يقول الشيخ الصالح. إذْ إنَّه لم تتوقَّف محاولات الاجتهاد خلال القرون العشرة من القرن الرابع الهجريّ إلى يومنا هذا. ويضيف أنَّه لم يعد ينبغي أن نهتمَّ بالقلَّة القليلة في مجتمعنا المعاصر التي لا تزال تعارِض الاجتهاد جهلًا أو كفرًا أو عنادًا، فتُنقص من نعمة الله على المتقدِّمين من السلف، وتُنكر أيَّ فضلٍ للمتأخِّرين من الخلف. بدلًا من ذلك، علينا أن نتوقَّف عن تمجيد الماضي والحزن عليه، وأن نبدأ بالتخطيط للمستقبل.
– المرأة: تبتعد أفكاره التقدّميَّة في المرأة عن الرؤية التقليديَّة التي يتقاسمُها العديد من العلماء المسلمين. فهو يؤكِّد في عدَّة مناسبات أنَّ التقاليد السلبيَّة الثقيلة المتعلِّقة بالمرأة لا تزال تُلقي بثقلها على الأعراف والعادات اليوم، فهناك فجوة اتَّسعت على مرِّ العصور بين حقيقة القرآن الكريم والحياة العمليَّة، ما أثار لدى بعضهم ظنًّا بالتناقض بين النصوص والوقائع. يدعو الصالح المرأةَ إلى التخلُّص من سلبيَّات الماضي الظلاميَّة والانطلاق إلى المستقبل، لتكون حرَّة متسلِّحة بقيمها الخاصَّة يدًا بيد مع الرجل. إنَّ الإسلام الذي يهدف إلى إنسانيَّة شاملة، لم يعد يحتمل تأخير تطوُّر المجتمع بحرمان المرأة من المشاركة المتكافئة على جميع مستويات الحياة العامَّة.
أفكاره في المرأة
1) يرتبط تحرير المرأة بظهور الإسلام.
2) إنَّ المجتمع الإسلاميّ، كغيره من المجتمعات البشريَّة الأخرى، قد هيمن عليه الرجل وبُني على صورته. وبإنزال المرأة إلى دورٍ ثانويّ قد عجَّل بانحطاطه.
3) عندما خلَق الله المرأة، لم يأخذها من ضلع من أضلاع الرجل.
4) ليس هناك ما يبرِّر أفضليَّة الرجل على المرأة بدعوى أنَّ القرآن الكريم يعطيه هذا الامتياز، بدليل قوله تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). وكلمة “درجة” التي تُرجمت بـمعانٍ تُفيد السلطة والهيمنة لا تعني غير درجة معيَّنة من التكليف أو مستوًى معيَّن من الواجبات والتكاليف.
5) الإرث كما ينظِّمه القرآن الكريم لا يُعطي حقوقًا للبنت فحسب بل أيضًا لأقارب المتوفَّى من النساء.
6) لا يجوز للأب أن يفرض إرادته على اختيار مَن يشاء من أزواجٍ لابنته، فلها أن تختار بعلها المستقبليّ بحرِّيَّة. ويجوز للمرأة أن تشترط على شريك حياتها جميع أنواع الشروط المشروعة عند إبرام عقد الزواج.
7) إنَّ الاكتفاء بزوج واحدة في الإسلام هو القاعدة وتعدُّد الأزواج هو الاستثناء فحسب. وإذا كان تعدُّد الأزواج من خصائص الرجل، فالمرأة حرَّة تمامًا في قبول التعدُّد أو عدم قبوله.
8) المرأة ليست أداة جنسيَّة ولا آلة لتكاثر النوع. فالمرأة هي أوَّلًا وقبل كلِّ شيء رفيقة الرجل، كما أنَّ الرجل هو رفيقها.
9) ليس في القرآن الكريم ما يمنع تحديد النسل. ولذلك يجوز للمرأة أن تستخدم وسائل منع الحمل إذا لم يعترض بعلها.
10) يجب أن يكون التعامل مع ما يُسمَّى بجرائم الشرف، في مواجهة المرأة الزانية، بإيقاع أقصى أنواع العقوبة على المجرم القاتل.
ثالثًا – اغتياله
حرص الشيخ صبحي الصالح، في خطاباته وخُطَبه في صلاة الجمعة، على إدانته بشدَّة المظالم والمآسي والتجاوزات التي يتعرَّض لها الشعبُ اللُّبناني وخصوصاً في الأحياء ذات الغالبيّة المسلمة نتيجة استباحة الميليشيات المسلَّحة المدينة، وارتكابِها كلَّ أنواع الفواحش من سرقة واغتصاب وإذلال وانتهاك للمقدَّسات. وكان يشير بأصابع الاتِّهام إلى نظام الوصاية حينها والقيادات التي تحمي العناصر المنفلتة. وكان يرفض، في مناسبات عدَّة، وجودَ ميليشيات مسلَّحة تنتهك حُرمة لبنان وتُنقِص من سيادته. ويدعو الجيش اللُّبنانيّ وباقي القوى المسلَّحة الرسميَّة إلى القيام بدورها في حماية السلم الأهليّ والدفاع عن لبنان، لأنَّ الجيش الرسميّ وحده الدرع الواقي لأمن لبنان والسدُّ المنيع الذي يحفظ وحدته ويمنع الفتنة.
وبسبب مواقفه الوطنيَّة الجريئة كان يتلقَّى تهديدات عديدة باغتياله. وفي صباح يوم ٧ تشرين اﻷوَّل/أكتوبر ١٩٨٦، عندما تأخَّر في الوصول إلى مدرسة اﻷيتام التي كان يُشرف عليها، بسبب ذهابه لتخفيف كرْب أحد اﻷطفال ومساعدة أحد طلَّابه الفقراء، قام رجلان مقنَّعان على درَّاجة ناريَّة بإردائه بثلاث رصاصات في رأسه، بينما كان يهمُّ بالنزول من سيّارة أجرة كانت تُقلُّه إلى دار اﻷيتام. وبمجرَّد وصوله إلى المستشفى، توفِّي متأثِّرًا بجراحه.
كان من المقرَّر أن تُعقد مائدة مستديرة تُنظِّمها دار الفتوى في 18 و19 يونيو 1988 لِمناسبة ذكرى اغتيال الشيخ صبحي الصالح. وقبل يومين من الموعد المقرَّر لعقدها ألغاها زعماءُ الأمر الواقع الذين كانوا يتصرَّفون بالنيابة عن السلطات الرسميَّة من دون تقديم أيِّ تبرير.
الخاتمة
أجمعت الآراء على وصف صبحي الصالح بالعالِم المُجدِّد، والمفكِّر الجريء، والخطيب الذي أسر العقولَ ببلاغة خُطَبه، والمُحاوِر والمفكِّر الذي أرسى أسس الحوار الدينيّ بين الأديان الإبراهيميَّة الثلاثة. كان رائدًا من رُوَّاد الانفتاح على الحضارات والثقافات، عالميا بأفكاره النهضويَّة حيث لم يُذكر اسمُه إلَّا مقرونًا بها، كدعوته إلى إحياء الاجتهاد وجعل القرن الخامس عشر الهجريّ قرنَ الاجتهاد تمهيدًا لليوم الذي ينجح فيه المسلمون في إقامة “مجتمع اجتهاديٍّ جماعيّ” على مستوى العالم الإسلاميّ .
كان الشيخ الصالح حلقةَ وصلٍ بين الإسلام وروح العصر والحداثة، داعيةً لإسلامٍ يتفاعل مع المكان والزمان في عصرنا، إسلامٍ يشارِك بكلِّ ثقةٍ وفخر بما لديه من فكر دينيٍّ وسياسيٍّ واجتماعيّ، من دون أن يتهافت مُنبهرًا بمنجزات الآخرين، أو يتوارى خوفًا من أن يُوصف ظُلمًا بالانغلاق وعدم القدرة على مواكبة التقدُّم المنشود.
وكان يحذِّر الجيلَ الجديد من علماء الدين من أن يكونوا أُناسًا يفتخرون بألقابهم ورُتبهم، بل بصفاتهم وأفكارهم وتخصُّصهم. وألَّا يكونوا عوائق تضيف شروطًا تعجيزيَّة على المجتهِد المستقلّ، عندما يختار أن يبتكر لنفسه مناهج خاصَّة به، من أجل النهوض بجوانب التشريع الإسلاميّ.
ويتطلَّب الأمر من الجيل الجديد من العلماء أن يُتقنوا لغة حيَّةً بالإضافة إلى لغتهم. وبفضل هذه اللغة الأجنبيَّة يستطيعون أن يَطَّلعوا على الثقافات الأخرى، وأن يكونوا أكثر انتباهًا إلى كلِّ قضيَّة مستجدَّة في العالم.
هناك جانب آخر من شخصيَّة الشيخ صبحي الصالح لا يعرفه بعضهم، وهو ميلُه إلى العمل الإنسانيّ والاجتماعيّ. فقد كان مؤسِّسَ مدرسة للأيتام في بيروت، وصاحبَ فكرةِ إنشاء صندوق نقديٍّ أُطلق عليه اسم “بيت مال المسلمين”[4]. وكان لهذا الصندوق شخصيَّة اعتباريَّة ويهدف إلى “النهوض بالمستوى الدينيّ والثقافيّ والاجتماعيّ والصحيّ للمسلمين في جميع مناطق لبنان”. وعلى الرغم من إقرار نظام هذا الصندوق بموجب قرار المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى إلَّا أنَّه استُبدل لاحقًا بنظامٍ آخر له الأهداف نفسها وعُرف بـ “صندوق الزكاة”.
ولا بدَّ في الختام من الإشارة، شخصيًّا، إلى تأثُّري بهذا الشيخ الجليل. وما زالت كلماتُه تتردَّد في خاطري بعد أن بلورَت شخصيَّتي الأكاديميَّة والدينيَّة ومنهجيَّتي الحواريَّة، وعلاقاتي في داخل المجتمعات التي كنت أحلُّ بها، طلبًا للعلم على مقاعد الدراسة أو مُحاضِرًا في جامعاتها ومؤسَّساتها التعليميَّة. اتَّصلتُ به بعد أن أنهيتُ دراستي في جامعة الأزهر، مغادرًا إلى فرنسا لاستكمال دراساتي العليا، ولألتمس منه قبسًا من ثقافته وانفتاحه من خلال تجاربه في أثناء إقامته الدراسيَّة في فرنسا. وقبل أن يُنهي حديثه وجَّه إليَّ نصيحة جامعة وشاملة، قائلًا: كنْ متفهِّمًا منفتحًا محترِمًا العادات المعمول بها في فرنسا، ولا تتردَّد في الاندماج مع السكَّان والحياة هناك. واعلمْ أنَّ عمق الالتزام الدينيّ الواعي المبنيّ على العلم لا يتعارض أبدًا مع الحداثة الملتزِمة، المهتمَّة برفاهيَّة الأفراد والمجتمعات.